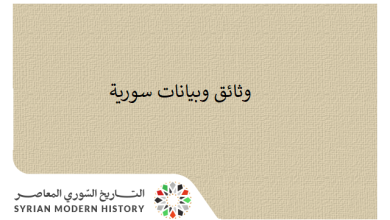تعتبر رحلة جمال القاسمي إلى القدس أول رحلة عربية يستخدم فيها صاحبها قطار الخط الحديدي الحجازي الذي وصل دمشق بـ عمان في العام 1903.
ولد علامتنا القاسمي في دمشق عام 1866م، ونشأ في بيت علم ودين، ودرس في المدرسة الظاهرية وتلقى علوم اللغة على شيخه الشيخ رشيد قزيها المعروف بابن سنان. ثم جوَّد القرآن على شيخ قراء الشام الشيخ أحمد الحلواني.
وهو المؤسس الفعلي إلى جانب الشيخ رشيد رضا للسلفية العلمية في بلاد الشام، وتعرض للاضطهاد، فسجن وحوكم واتهم بابتداع مذهب ديني جديد اسمه المذهب الجمالي، وفرضت عليه الإقامة الجبرية بعد محاولة اغتيال الشيخ رشيد رضا في الجامع الأموي عام 1908، ولو أنه أدرك العام 1916 لكان أحد المشنوقين على يد جمال باشا السفاح، إذ كان جل المشنوقين من تلاميذه ورفاقه. وكانت وفاته في الثامن عشر من شهر نيسان 1914م. ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق.
للقاسمي مؤلفات كثيرة بلغت 113 عنواناً من أهمها قاموس الصناعات الدمشقية، جمع فيه هو ووالده سعيد القاسمي جميع الصناعات والحرف التي كانت موجودة في عصره، ويعد بحق واحداً من أهم المراجع عن الحياة الاجتماعية في عاصمة الأمويين أواخر القرن التاسع عشر.
تنطوي رحلة القاسمي إلى القدس في العام 1903 على معلومات مقتضبة عن مدن فلسطين التي مر بها وهي: القدس وبيت لحم والخليل ويافا، ووصف بعض ما رآه فيها، وهي كما قال كانت تعاني من قلة العلماء، ومرد ذلك هو ضعف الحركة العلمية بشكل عام في أواخر العصر العثماني، ليس في فلسطين وحدها بل في عموم بلاد الشام.
وسبب الاقتصاد في عبارات هذه الرحلة طبيعة الشيخ القاسمي الناقمة على مظاهر التقليد الأعمى، فهو لم يشأ – وهو قادر على ذلك- أن يخط رحلته بإسهاب أو بتكلف لغوي، وقد أشار للقراء إلى الكتب التي يمكن أن يأخذوا عنها معلوماتهم التاريخية والجغرافية المتعلقة بالموضوع.
في حوران
يقول الشيخ القاسمي في مفتتح الرحلة: “لم أزل كثير التشوق لزيارة تلك الأماكن المباركة منتظراً للفرصة حتى حانت، فشددنا ساعد الهمة، وأبرزناها من القول إلى الفعل، وذلك في أواخر شهر محرم فاتح سنة 1321، نيسان 1903م، ونوينا الذهاب من طريق البر..
ثم في صباح الأحد 29 محرم المذكور خرجنا من دارنا طلوع الشمس، بعد أن قرأنا ورد المسافر، وجيء لنا بعربة فوقفت أمام حارتنا وهي زقاق العلامة المكتبي ظاهر باب الجابية، المجاور لجامع الزيتونة، فاستطرناها إلى محطة الميدان، وسار لوداعنا لفيف من الأهل والأصحاب”.
وتعد محطة الميدان ثاني أكبر محطة في الخط الحديدي الحجازي بعد المحطة المركزية، وهي تقع في قرية القدم جنوبي حي الميداني، وكانت بداية رحلة محمل الحج الشامي حيث كانت تقام فيها طقوس الوداع التي يتصدرها شيخ الطريقة السعدية. وقد اختفت هذه الطقوس الاحتفالية مع تشغيل الخط الحديدي الحجازي الذي انتهى العمل به في العام 1908.
بعد ذلك يتابع حديثه عن تحرك القطار الذي يسميه “وابور” جرياً على عادة أبناء ذلك الزمن قبل أن يولّد المجمع العلمي في دمشق اسم القطار بسنوات، فيجتاز “تلك البلاد الحورانية المخصبة المؤنقة”، إلى أن يصل إلى قرية مزيريب قرب الظهر.
وتعد قرية المزيريب من أهم محطات طريق الحاج الشامي، إذ ذكرها الرحالة الذين كتبوا عن رحلات حجهم، طوال العصر العثماني، ومن مزيريب إلى درعا التي يقول عنها إن أحد وجهاء دمشق طيَّر خبر قدومهم إلى قاضي درعا، الذي حاول استبقاءهم عدة أيام، ولكنهم أبوا ومضوا على متن القطار الحجازي إلى عمان، فوصلوا إليها قبيل الغروب.
في عمان والسلط
يصل الشيخ القاسمي وصحبه إلى عمان بعد الغروب بنحو ساعة. ويتحدث عن استقبال فقهاء الجراكسة ووجهائهم لهم، يقول إنهم أقاموا فيها عشرة أيام.
وفي وصفه للمدينة يقول: “تجولنا في خلال هذه المدة في معظم أرجائها، وشاهدنا آثارها وخرائبها، المدهشة بقاياها، وبعض مقابرها الحجرية التي أخذت في الظهور في ناحيتها القبلية، من بيت هناك، وصعدنا إلى جبلها ورأينا رسوم تلك القمة والحصون والأسوار والأعمدة المنقضة فيه، وسرنا يوماً إلى مداخل سرداب تلك القاعة من جهة جنوب البلدة تحت طرف جبلها، وأبصرنا غرائب جمة، وآثار عمران سلفت مدهشة.
وقد قيض المولى لنا في عمان أحد الأخلاء الدمشقيين المقيمين ثمة لمأمورية، فبذل وسعه في الإكرام والإيناس الزائد، ورأينا من إقبال فقهاء الجراكسة ووجهائها المقيمين هناك ما لم نتأمله، فكانوا يتسابقون للاجتماع بالمحال التي نتنزه في فيحائها، ونقيم سحابة النهار في وارف أفيائها.
ولم تفتر ولائمهم لأجلنا في الصباح والمساء، ولهم تأنق في تهيئة الشاي، واقتصاد في المعيشة غريب.. هذا ولم تخل بحمده تعالى مجامعنا عن مذاكرات علمية ولطائف أدبية، ومفاكهات تستروح إليها النفوس، واستصحاب كتب أشهى لدينا من منادمة العروس. هذا وتجارة البلدة آخذة في المزيد، كما أن عمرانها، لكثرة النازلين فيها، وتوالدهم، في تقدم أيضاً.. وقد كانت مدة إقامتنا في عمان عشرة أيام”.
وكان الجراكسة قد وصلوا إلى عمان وباقي مناطق بلاد الشام في العام 1878 بعد أن مكثوا في البلقان فترة اضطروا للرحيل بعدها إلى بلاد الشام بعد أن نشبت بينهم وبين البلغار معارك دموية، وقد منحتهم السلطنة في عهد السلطان عبد الحميد قرى وأراضي في مختلف أرياف الشام من حلب إلى عمان.
وبعد عشرة أيام من الإقامة في عمان يتوجه الشيخ القاسمي وصحبه إلى السلط في طريقهم إلى القدس. وحول السلط يقول: “في الصباح قدم لزيارتنا وجهاء السلط ولفيف من موظفي حكومتها، ثم أخذ يتوافد علينا من عرفنا قبل، ومن تعرف بنا هناك، ليلا ونهارا، وغصت مجالسنا بهم وزادت على مجتمعات عمان، وكان أحد رفقائي يقول لي: إن طالعنا طالع جمع شمل، وصفو وقت واستحسنت من منتزهات السلط عين الجادور، ففي أغلب الأوقات نستغرق لديها النهار إلى المساء، ومعنا كتبنا التي هي زاد أرواحنا.
وكان يأتينا غداؤنا بحمده تعالى إليها، ويفد إلينا عند المساء بقية أصحابنا، ونقرأ عليهم مما معنا ويمضي الوقت في مسائل ولطائف. وهكذا قضينا عشرة أيام كانت مظهراً للأنس والسرور، بحمد الله الشكور، وانتزهنا يوماً جهة قبة الجادور بين حدائق العنب، وتجولنا في تلك الرياض الشماء.. وقد أخذ الآن عمران السلط في ازدياد وأصبحت تشاد فيها البيوت المرتفعة بنهضة عجيبة وأكثر أهلها من نابلس”.
ويتوجه الشيخ القاسمي وصحبه إلى فلسطين عبر وادي شعيب ومنه إلى “جبال الغور الهائلة التي كان من الحكمة قطعها ليلاً”، فيصلون إلى نهر الأردن فيجتازونه عبر جسر خشبي يأخذ منهم متعهده ضريبة، ثلاثة قروش للراكب، ونصف قرش للماشي، ويذكر أن “ضمان هذا الجسر الخشبي ألف وعشرون ليرا عثمانية تضمنه الدولة في كل عام”.
ويضيف القول: “نزلنا في دار حكومة مديريتها، ريثما يبرد الهواء ونؤدي الفرض، فصلينا الظهر وتناولنا الشاي بعد القيلولة، وركبنا منها إلى خان بين أريحا والقدس وهب الهواء عاصفاً، وبرد الجو، فاضطررنا إلى المبيت، لا سيما وفي المسافة إلى القدس بقية بعد، فصلينا المغرب في حجرة فيه واسعة، ونمنا فيه، و سرنا من ذلك الخان، إلى أن أسفر الوقت فنزلنا على جانب الطريق، وأدينا الفجر، ثم ركبنا، الطريق أخذت بالمارة تقبل وتدبر منها إلى أن بدت أعلام قرية يقال لها العيزرية ومنها لاحت مباني بيت المقدس من ضواحيه.
يدخل الشيخ القاسمي وصحبه مدينة القدس من باب الأسباط ضحوة الثلاثاء في 22 من صفر الموافق الخامس من أيار، فأنزلهم المكاري في خان هناك، وبعد أن وضعوا أمتعتهم في حجرة فيه مضوا إلى الحرم الشريف، فيقول واصفاً مشاعره: “لا تسل عما هجم علينا من السرور المفرط، وانشراح الصدر، وبهجة النفس، وانتعاش الفؤاد، وحسبناه قطعة من الجنة قد دخلناه حامدين شاكرين لفضله، ونحن نكفكف الدمع فينهمر”.
ويضيف واصفاً الاستقبال في قبة الصخرة: “ثم وردنا الصخرة الشريفة، ورأينا آثارها ثم استقبلنا شخص من خدامها، وسألنا عن نزلنا، فقلنا: الآن أمتعتنا بالخان، فدلنا على الزاوية الداودية، وقال: هي منزل الفضلاء القادمين لهذه البلدة، ولها طعامية سلطانية، لذلك ذهبنا بعد العصر إليها، فاستقبلنا قيموها الكرام، وأصعدونا إلى غرفة فخيمة، ثم أدوا علينا في تناول العشاء والمنام فامتثلنا، وشاهدنا منهم غاية الترحاب والإيناس، ورغبوا أن نكون نزلاءهم مدة مقامنا فأبينا، رغبة في أن يكون نزولنا في الحرم نفسه”.
وبالفعل تتحقق رغبة الشيخ ويجد غرفة من غرف الحرم ويقول عن ذلك” “في يوم الأربعاء طافوا بنا في الحرم، فتقاطرت علينا أرباب الحجرات في صحن الحرم، وحول الصخرة، كل يرغب أن نأخذ حجرته إن شئنا، ثم دلنا شخص على حجرة داخل الحرم الأقصى في قبليه، جهة منبره الأيمن، جانب مقصورة الحديد، فآثرتها على كل حجرة لقربها من الحرم الذي هو البغية من الرحلة، وتيسر بيت للطهارة فيها، ولإشراف برّانيها على ما حول الحرم من المباني والبطاح الفيحاء، ولقد زارني من لا أشك في صلاحه وقال لي: أبى الله إلا أن تكونوا في حرمه، وأضياف بيته، فأبكاني سرورا، وسجدت لله شكرا”.
ويمضي الشيخ ليله في مراجعة “أنس الجليل بتاريخ القدس والخليل” للقاضي أبو اليمن الحنبلي، فيجد أن المنزل الذي نول به في الحرم كان في الأصل زاوية، تدعى “الزاوية الخنثنية” بجوار المسجد الأقصى، خلف المنبر، وقال إن واقفها هو الملك صلاح الدين على رجل من أهل الصلاح، وهو الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد الشاشي، المجاور في البيت المقدس.
ويقول الشيخ القاسمي إن مجاور الحرم طلب منه قراءة درس عام، فأبى خشية أن يصيبه العجب والغرور، فشكى له المجاور “فقد العلماء من تلك الديار المباركة”. وهي معلومة مهمة كونها تكشف عن هذا الجانب غير المعلوم عن بيت المقدس، حيث تراجعت مكانته العلمية منذ مطلع العصر العثماني، بعد أن كان مركزاً تعليمياً طالما قصده الحجاج لأخذ العلم عن علمائه المجاوري
في المدينة المقدسة
يتحدث الشيخ عن المكتبة الخالدية ويمتدح مقتنياتها، ثم يتحدث عن زيارته بمعية دمشقي مقيم في القدس مقام السيدة مريم عليها السلام فيه، وهو في كنيسة تسمى الجثمانية. ثم يزور موقع جبل الزيتون الذي يسميه باسمه القديم “طور زيتا”، ويقول: “صعدت إليه، وأراني غالب مزاراته، ومنها مصعد السيد عيسى عليه السلام، على ما يرونه، وهو صخرة فيها أثر قدم داخل قبة، وجلسنا في الزاوية العلمية في جواره طلباً للرحمة، وقدمت كؤوس المرطبات، ثم انحدرنا منه. وبعد عصر ذلك اليوم سار بنا رفيقنا المذكور إلى كنيسة القيامة الشهيرة، فتقدمنا أحد بوابيها المسلمين، وأرانا جهاتها العلوية والسفلية، موضعاً موضعاً. ثم انعطف بنا رفيقنا إلى الخانقاه الصلاحية، وصعدنا إليها، واحتفل بنا قيمها، وجلسنا ثمة برهة، وأرانا غرفها وطباقها العلوية”.
ويواصل وصف معالم المدينة المقدسة: “ثم في صباح الثلاثاء ذهب بنا رفيقنا المذكور إلى نواحي البلدة، وأرانا غرائب أماكنها، ومنها دار مطبعة للاتين مهمة جداً، مشتملة على دار حدادة وطحن بأدواتها، ويديرها وابور بخاري. فاحتفل بنا قيموها. هذا وفي كل ذلك ننقلب إلى حجرتنا في الأقصى بسرعة، بحيث لم تفتنا بحمده تعالى في مدة إقامتنا الصلاة أول الوقت فيه، إلا ما كان وقت المغرب أحياناً، لوجودنا في دعوة بعض المحبين..
ثم في يوم الثلاثاء المذكور زارنا قبيل العصر في حجرتنا أحد وجهاء القدس، وغب أداء العصر نادى بمن يأتي بمفتاح الأقصى التحتاني، المنحدر في درج أمام أبواب المسجد، فدخلنا وصلينا فيه ركعتين تحية المسجد، ثم انقلب بنا إلى محل البراق غربي المسجد، فانحدرنا في درج إليه، إلى موضع الحلقة، وصلينا ركعتين تحية المسجد أيضاً. ثم ذهب بنا من باب المسجد، المعروف بباب الماربة، في أواخر الجهة الغربية من صحن المسجد. وقد ذكر صاحب أنس الجليل أن موقتي الحرم ذهبوا إلى أن هذا الباب هو الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ثم تجولنا خارج السور، وأشرفنا على عين سلوان، وتلك المناظر المباركة، وكنا في دعوة أحد الصلحاء ليلتئذ”.
بيت لحم والخليل
وحول زيارته لبيت لحم ومدينة الخليل قال: “صباح الأربعاء سلخ صفر، عقدنا النية على المسير إلى بلدة الخليل عليه السلام، وبينما نحن في التهيؤ لاستئجار عربة، وإذا أحد محبينا قادم لزيارتنا، وقد هيأ لنا عربة تنتظرنا، فحمدنا المولى على هذا التيسير، وسرنا في الحال من حجرتنا في الأقصى، وركبنا العربة من باب العمود قبيل الظهر، ولا زلنا حتى وصلنا بيت لحم، فدخلنا للمكان المشهور بولادة السيد عيسى عليه الصلاة والسلام فيه، وأرانا قيمه محل الولادة، والنخلة، وما جاورهما، وتجولنا في أنحاء ذاك المكان، وأحببت أن أصلي ركعتين عند محل الولادة، اتباعاً لما ورد في قصة المعراج.. ثم خرجنا منه إلى جامع البلد، فصلينا الظهر جماعة، واشترينا من بعض التجار ثمة بعض قطع صدفية، أعددناها هدية للأولاد والعيال”.
ويتحدث الشيخ القاسمي عن انفراد بيت لحم “بدقة الصنعة في التفنن بالقطع الصدفية، بما يدهش الألباب”. ويضيف واصفاً طريقه إلى الخليل: “سرنا متوكلين عليه تعالى في ذاك الطريق البهيج، وقد راقني منه وادي بيت جالا، المملوء بشجر الزيتون، ووقفنا في بعض المحلات لإراحة الدواب، ومنها لدى عيون عذبة، كعين عروب، وعندها صلينا العصر، ثم عين الدورة..
وأبصرنا في الطريق البركة التي فيها نبع ماء يساق للحرم الأقصى الشريف، وقرية حلحول التي يقال إن بها قبر سيدنا يونس بن متى، ثم تبدت لنا أعلام مدينة الخليل عليه السلام قرب المغرب، فسرنا توا إلى الجامع الشريف، ودخلنا رباطاً في جواره، توضأنا فيه ثم دخلنا الجامع، وغب صلاة المغرب والنافلة جاءنا أحد الطلبة فيه وسلم علينا، وجال بنا في أنحائه، لزيارة تلك المقامات الجليلة.
ثم بعد زيارة الجميع عليهم الصلاة والسلام، استندنا إلى المنبر، فتحلق لدينا من أهالي المسجد ثلة، وسألني بعض الطلبة هناك عن بعض مسائل، وغب الجواب طلب مني قراءة درس في الصباح فاعتذرت بأنا على جناح السفر، ومقامنا قليل. وغب أداء العشاء سار بنا إمام الحرم الحنفي وخطيبه، وأنزلنا في داره ظاهر البلدة، على غاية من الرفاهية، فحمدنا الباري تعالى على ما ألهم”.
العودة إلى بيت المقدس
ويعود الشيخ إلى القدس ويروي حلماً رآه حول بيت المقدس، ويذكر أن مقصده من هذا التدوين “لتكون تذكاراً لي ولمن يتشوف من وقتها من أهلي، اقتصر على هذه الكلمات، وأضربت صفحاً عن تاريخ البلاد التي مررت عليها، وذكر جغرافيتها، وحالها قديماً وحديثاً، خشية الطول، والخروج عن الموضوع”.
ويقول: “من أراد الوقوف على شأن البيت المقدس، فعليه بأنس الجليل، وكتاب الروضتين لأبي شامة فإنه تطرق لكثير من مهمات آثاره، لا سيما من نثر مثل القاضي الفاضل، والعماد، كاتبي الحضرة الصلاحية. وكنت أراجع لجغرافية ما مررنا عليه من الجبال والبلاد والقرى كتاب الجغرافية العمومية، وكتاب تاريخ المملكة السورية، وكتاب دليل الزوار، ففيها من تحقيق الكتابين لبعض شؤون ذلك ما يزداد به إحاطة، ولسهولة الوقوف على هذه الكتب بوساطة طبعها وانتشارها، اكتفينا بالإحالة عليها”.
إلى يافا
وفي صباح السبت 3 ربيع الأول يبارح الشيخ القاسمي القدس عن طريق “محطة الوابور” بعربة ركبوها من باب الخليل، ويقول: “ألفينا هناك جمعاً من صلحاء الحرم، واختيار القدس، وفدوا لوداعنا أيضاً، فشكرنا سعيهم. ثم تحرك “الوابور” ضحوة النهار المذكور، وجاب في بطاح جميلة المنظر، حتى وصل يافا قبيل الظهر”.
ويضيف: “صادفنا في “الوابور” أحد فقهاء قرية اللد ركب منها قاصداً يافا أيضاً، فترافقنا، ونزلنا جمعياً في دار مفتي يافا، العلامة المفضال، والشاعر البليغ، السيد الشيخ علي أفندي أبي المواهب؛ ابن الأستاذ الكبير الشهير الذكر، الشيخ حسين الدجاني، فأجل وفادتنا، وسررنا بمحاورته العلمية، ومطارحته الأدبية، واطلعنا على جملة من تأليفاته اللطيفة، وشعره الفائق”.
ثم يصف “متنزه الألمان، الذي يقول عنه إنه “ضم صنوفاً من الطيور الغريبة، والحيوانات العجيبة”. ويتحدث عن زيارة جامع يافا الكبير مراراً، ومسجد في جوار دار المفتي مطل على البحر أحياناً.
العودة بحراً
ويعود الشيخ من يافا إلى دمشق عن طريق البحر فيقول: “سار المفتي معنا إلى الميناء، وركبنا الزورق، ولطف المولى، وله الحمد، حيث لم يكن في البحر تموج زائد، والمسافة إلى الوابور (السفينة البخارية) كانت نحوا من ثماني دقائق. ثم ارتقينا إلى الوابور. وبدأ الدوار يأخذ بنا، فأشير إلينا بالاضطجاع. ثم سار من ميناء يافا الساعة التاسعة من النهار، ولم يزل يشق عباب البحر إلى أن وافينا بعناية الله وفضله ولطفه ثغر بيروت، بعد طلوع الشمس بأقل من ساعة”.
بعد ذلك يركب الشيخ القاسمي القطار من بيروت ويعود إلى دمشق بعد أربعين يوماً من الغياب عن بيته.
اقرأ:
نزيه مؤيد العظم: رحالة شامي في رحاب صنعاء
حين حاول الرئيس شكري القوتلي الانتحار في السجن