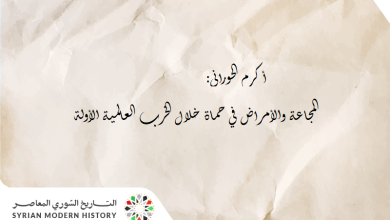على الطريق إلى زيارة أهلنا في الجولان، وخلال عبور قصير الأمد في مدينة سمخ الفلسطينية، فجر 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، صحبة ياسر خنجر وعلاء الصفدي وفاروق مردم بك؛ استعدتُ الفقرات التي دوّنها أكرم الحوراني عن فترة تطوّعه في القوّة السورية ضمن «جيش الإنقاذ»، أوائل 1948، وخاصة التضحيات الجسام التي بذلها الضباط السوريون لتحرير المدينة من العصابات الصهيونية. ونقل الحوراني عن مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس، أنّ الجيش السوري كان ناشئاً وقليل العدد والعدّة، ولكن أفراده استبسلوا في جميع المعارك التي خاضها مع الإسرائيليين، «حيث كانت نسبة من استشهد من ضباطه أكبر من أي نسبة معروفة في الجيوش المحاربة».
كذلك توجّب أن أستذكر أحد الأبناء البررة لهذه المدينة، لأسباب فلسطينية هذه المرّة، وإنْ كانت غير بعيدة عن سوريا، وتتصل بالشعر وليس بحرب فلسطين وأنساق التضحية مقابل الخيانة، والبسالة مقابل الغدر. حضر في البال ابن سمخ الشاعر الفلسطيني فواز عيد (1938 ــ 1999)، الذي ولد هنا قبل أن تُهجّر عائلته إلى القنيطرة السورية، حيث درس وتخرج من جامعة دمشق، وعمل مدرّساً لدى وكالة الغوث؛ وفي سوريا أنجز مجموعاته الشعرية الأربع، وفي ترابها دُفن بعد رحيله الفاجع. وإذْ كان عيد قد عانى من ظلم فادح لجهة إنصاف موقعه المتميز داخل مشهد الشتات في الشعر الفلسطيني خلال ستينيات القرن الماضي، أسوة بالتقصير النقدي الذي حاق بمجايليه من أمثال محمد القيسي وعز الدين المناصرة وأحمد دحبور ومريد البرغوثي؛ فالسبب الأبرز لا يعود إلى تأخّر الانتباه إلى علوّ قصيدته وخصوصية صوته وسطوع شعريته، فهذه وسواها عناصر تأكدت دون إبطاء، بل إلى حقيقة انشغال النقد العربي بشعر الأرض المحتلة ونماذج محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، وطغيان ما سُمّي «شعر المقاومة».
وفي عددها لشهر آذار (مارس) 1961، كانت شهرية «الآداب» اللبنانية قد حملت قصيدة أولى من عيد بعنوان «خرائب»، تصدّرها الإهداء التالي: «إلى الرفاق الباحثين عن رغيف شمس… وقطرة ماء»؛ وكان جلياً أنّ النصّ يعكس مراساً في الكتابة الشعرية ليس طارئاً، وليس وليد هذه القصيدة، رغم أنّ تأثيرات بدر شاكر السياب، وخاصة «أنشودة المطر» التي كانت «الآداب» قد نشرتها في عدد حزيران (يونيو) 1954، واضحة وبيّنة: «نهوّم في العراء على رمال الليل.. في الظلمة/ لنسأل عنك يا آذار.. في الينبوع.. في النسمة/ وعند مساقط الشلال.. تحت سواعد الكرمة/ ظماء نحن يا آذار.. موتى.. هات فاسقينا/ حيارى.. خائرات.. يلتمسن الماء.. لو قطرة/ تظل تدور في الأعماق لاهثة بها زفرة/ غداً آذار يأتينا/ مع الإشراقة الأولى/ غداً يأتي وفي أكمامه خمر ليروينا». ومن حيث الشكل، كان عيد ينوس ــ ليس دون مشقة في اجتهاد المزاوجة ــ بين شكل العمود وشكل التفعيلة؛ وبين لغة الشعراء التموزيين ورموزهم ومناخاتهم، ومعجم شعر الالتزام والبحث عن الخلاص والقيامة؛ مع ميل لافت إلى ضبط الميزان الوجداني للقصيدة بعيداً عن التهويل العاطفي.
بعد 15 شهراً، في عدد حزيران (يونيو) 1962، سوف تنشر «الآداب» قصيدة جديدة من عيد، بعنوان «الأبواب»، تحمل هذه المرّة الكثير من روحية التجديد؛ سواء من حيث الشكل، إذْ تستقر على صيغة التفعيلة دون أيّ جنوح إلى العمود المقنّع أو التقفية الرتيبة، كما تختار مقطع الكتلة وليس التقسيم إلى سطور فقط؛ أو من حيث المحتوى، إذْ تدشّن سلسلة الموضوعات التي ستصبح علامة فارقة في نصوص عيد اللاحقة. وهكذا، في باب «المطر»، كتب عيد: «الريح دائخة تدق جبينها بالسور، تنثر شعرها غضبى، تراجع في سفوح التل أسيجة الكروم/ وتظل تركض.. ثم يدركها العياء.. تخور.. تسقط في شقوق الليل.. ترقد في مدى الخدر السحيق».
والأرجح أنها لم تكن مصادفة، حسب قراءتي الشخصية، أن هذه القصيدة تحديداً تستهلّ مجموعة عيد الأولى «في شمسي دوار»، التي صدرت سنة 1963، وكانت في عداد مجموعة من الأعمال الشعرية حرص الراحل سهيل إدريس على إصدارها عن «دار الآداب» في سياق حماسه الفائق لشكل التفعيلة، أو «الشعر الحرّ» في التسمية الأخرى، أمام زحف قصيدة النثر ومدرسة مجلة «شعر». المجموعات اللاحقة، «أعناق الجياد النافرة» و«من فوق أنحل من حنين» و«بباب البساتين والنوم»، فضلاً عن قصائد جُمعت بعد رحيله تحت عنوان «في ارتباك الأقحوان»؛ سوف تنقل عيد إلى مصافّ أرقى ضمن ثلاثة مشاهد شعرية في الواقع: الفلسطيني، وليس بالضرورة بسبب من حضور القضية في القصيدة؛ والسوري، لأنّ عيد كان في قلب الحركة الشعرية السورية، وحملت قصائده موضوعات شتى ذات صلة بسوريا ودمشق؛ والعربي، ثالثاً، لأنّ تجربته أخذت تتأصل على نطاقات أوسع فأوسع في قلب معترك التجريب الشعري العربي.
وعلى عتبات مدينة سمخ، في تلك البرهة الفائقة من ذلك الفجر، في غمرة انجلاء البواطن الأعمق من الآصرة الفلسطينية ــ السورية؛ حضر أكرم الحوراني، وردّنا شاطئ طبرية إلى شعر فواز عيد: «.. وضباب الفجر أعمى/ يلثم الحيطان/ والبلور يلتفّ إلينا/ عبر باب من دمشق النائية».