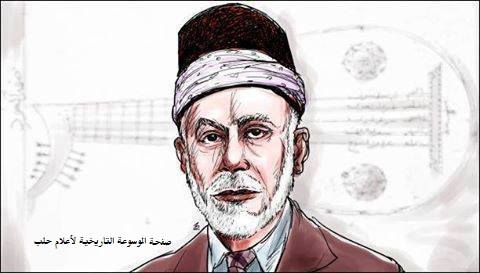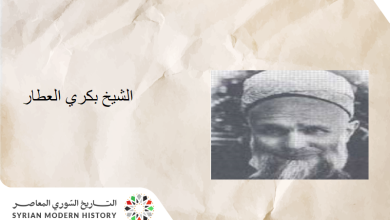عمر البطش .. شيخ الكار
1885 – 1950
في عام 1910، اعتزل ذو الخامسة والعشرين، ابن حي الكلاسة في حلب، مهنة البناء التي كان قد بدأ مزاولتها منذ صغره، وتحوّل عنها قاصداً الموسيقى. حينها، كان هذا الفن يُسمّى بـ “صنعة شيوخ” يطغى شكلها الديني على كينونتها الفنية المكتنزة، بعكس الموسيقى الشعبية البسيطة التي كانت في متناول الجميع.
هكذا، تعلّم عمر البطش (1885 – 1950)، الذي تحلّ ذكرى رحيله اليوم، الموشحات والمقامات وأصول الإيقاع، على يد شيوخ كانوا يشكّلون نواة الموسيقى في حلب، مثل أحمد عقيل وأحمد المشهدي وصالح الجذبة. كما أخذ عنهم “رقص السماح”، الذي كان يؤدّى في مجالس الحفلات الدينية، وراح يرتاد الزوايا الصوفية، ليطّلع على أعمال هذه الفئة التي تولي الموسيقى اهتماماً كبيراً.
وما لبث أن تمكّن من فصول الذكر ذات الفصاحة اللحنية، وصار يشارك في تأديتها، إلى أن اندلعت الحرب العالمية الأولى، فكان مصيره أن يفارق حلب أربع سنوات، ويلتحق بالجندية العثمانية، التي عينته في فرقتها الموسيقية في دمشق.
عندما تشكل الوعي الموسيقي لدى الشاب الذي حفظ مئات الموشحات والألحان، لم يكن مفهوم الموسيقى عند المجتمع الحلبي متحرراً ليسمح بتقديمها خارج الإطار الديني، رغم أن بعض معاصريه كانوا على علم كبير بالموسيقى وإلمام بأحوالها؛ فبدأ البطش والعديد من مجايليه (علي الدرويش وتوفيق صباغ وأحمد الأبري)، تقديم موسيقاهم بعيداً عن الطقس الديني، مُتّجهين نحو تأسيس دعامات تُعرّف حدودها وترسم ملامح خاصة بها.
“صاغ مؤلفاته بما يوافق بين كل من الكلام والإيقاع، ويعزّز من انسيابية ورشاقة اللحن بينهما”
في حياته الموسيقية، انتهج البطش التجديد في أعماله، فخرج عن وحدة الوزن والرتابة اللحنية التي كانت تثقل القوالب الموسيقية بشقيها الغنائي والآلي، وأغنى فن الموشح من خلال إضافاتٍ أعطت هذا القالب الغنائي متانة في البنية اللحنية، وجمالية شعرية أكبر. ذلك أنه صاغ مؤلفاته بما يوافق بين كل من الكلام والإيقاع، ويعزّز من انسيابية ورشاقة اللحن بينهما. وبهذا، أبرز نفسه كوشّاح بارع، عبر توشيحات وقدود وأدوار أجاد تلحينها، مثل موشحَيّ “يا ناعس الأجفان” و”رمى قلبي رشا أحور”، ودور “يا قلبي مالك والغرام”.
ولا شك في أن الموشح الحلبي، بعد البطش، تطوّر كثيراً عما قبله، وصار في مستوى الموشح الأندلسي، بل إنه غدا تطوراً له، مستفيداً من الإضافات التي قدّمها، إذ اشتغل على موشحات قديمة النظم والتلحين، وأضفى عليها تشكيلاً مغايراً. كما لحّن نحو 150 عملاً، بين الموشحات والقدود والنواطق المتعددة الأجناس والأنغام، واستخدم إيقاعات النقش، التي يتنقّل عبرها الموشح بين ثلاثة إيقاعات مختلفة، ما أعطى أعماله مرونة، أتاحت له استعراض مقامات موسيقية صعبة ونادرة التلحين، طوّعها من خلال قدراته التقنية العالية.
في مطلع الثلاثينيات، كان الشيخ المُحدِّث قد ذاع صيته بين الفنانين، وصار مقصداً لكثيرمن المشتغلين بالموسيقى في سوريا وخارجها، ومن أبرزهم المصريان سيد درويش ومحمد عبد الوهاب. الإدراك العميق والروح الموسيقية الحيوية لدى الفنان الحلبي، أفضيا به إلى تجربة الغناء المسرحي الذي يتيح للملحن حرية واسعة في تأدية الأصوات، ومساحة أكبر عبر تجسيدها بحركات راقصة من فن السّماح؛ فاشتغل على إبراز عنصر الحركة في الموسيقى، وقدمه بأسلوب مسرحي، كما شكّل لوحات راقصة مثّلها بصفوف ودوائر متداخلة من الراقصين، وأدخل فيها لأول مرة رقصات للفتيات، في حين كان رقص السماح قبله مقتصراً على الرجال.
تعاون صاحب “يمرّ عجباً” مع عدد من الموسيقيين والمهتمين في مشاريع وأعمال مختلفة، وعمل كعازف إيقاع في فرقة “علي الدرويش” الموسيقية. وكان لصداقته مع الشاعر فخري البارودي أثر في ما قدّم لاحقاً، حيث انتقل إلى دمشق عام 1947، ليدرّس “رقص السماح” لطالبات مدرسة “دوحة الآداب”، بدعوة من البارودي، الذي كان مهتماً بجمع التراث الموسيقي العربي. وفي عام 1943 سجّل مع مجموعة من طلابه العديد من الألحان في معهد الموسيقى الشرقية التابع لهيئة الإذاعة السورية، حديثة التأسيس حينها، واستمر في التدريس حتى عاد إلى حلب عام 1949، ليدرّب الفرقة الغنائية التابعة لإذاعة حلب. وكان من تلاميذه في حلب حسن بصّال وعبد القادر حجار وصباح فخري وصبري مدلل، وفي دمشق درّس زهير وعدنان منيني، وعمر عقاد.
“كان من تلاميذه في حلب حسن بصّال وعبد القادر حجار وصباح فخري وصبري مدلل”
اللافت في مسيرة البطش هو عدم مشاركته في مؤتمر الموسيقى العربية الذي أقيم في القاهرة عام 1932، حيث شمل المؤتمر عدداً كبيراً من المشتغلين بالموسيقى الشرقية والغربية والمستشرقين، بهدف وضع “منهجية عصرية للموسيقى العربية”، بما يحفظ طبيعتها الخاصة. لكن انعقاده كان نقطة تحوُّل سلبية، إذ لم يردع الخلل الذي أصاب الموسيقى العربية، بل ظهرت فيه بوادر مسح هويتها، ومحاولة إبدالها بإسقاطات من الموسيقى الغربية المختلفة تماماً في أساسها.
من هنا، كان على عاتق موسيقيي تلك الفترة – سواء في حلب (عمر البطش، علي الدرويش، محمد رجب، إلخ)، أو في مصر (سامي الشوا، محمد عبد الوهاب، محمد كامل الخلعي، إلخ)، أو في العراق (عثمان الموصلي) – الحفاظ على الموروث الموسيقي، وحفظه من الضياع، في ظل غياب أدوات التدوين. وكانت الذاكرة الموسيقية في تلك المرحلة قائمة على ما نقل بالحفظ والتواتر الشفهي، أو بالمخطوطات الورقية، وحتى حين درج تسجيل الفونوغراف، كان وجوده نادراً في بلدان كانت تقضي سنيها بين استعمار وانتداب.
بعد بلوغه الستين، أصيب الشيخ البطش بضرر في بصره أواخر الأربعينيات، وضعُف نظره، فنظم قصيدة تصف ما عايشه حينها، جاء فيها: “قلت لما غاب عني نور مرآك المصون/ شفّني والله سقم فيه قد ذقت المنون/ وعيوني من نحيبي جاريات كالعيون/ وجفوني ما كفاها ما جرى حتى جفون/ هام قلبي زاد وجدي فمتى وصلك يكون/ غاب عن عيني ضياها يا قمر داري العيون”، ثمّ لحنها بنغم النهاوند، ناقشاً إيّاها بثلاثة إيقاعات.. وكانت آخر أعماله(1).
(1) موقع العربي الجديد .. بقلم عبد الواحد الخمرة.
باسل عمر حريري، الموسوعة التاريخية لأعلام حلب